بساطة الأطفال وعبء الأسئلة بين الكبار
دخل شاب إلى مقهى يحتسي قهوته. بمقابله فتاة جالسة تقرأ كتابًا. مالت برأسها، نظرت إليه وابتسمت، ثم قامت من كرسيها وذهبت إلى طاولته.
فكان الحوار كالتالي:
الشابة: مرحبًا، أريد التعرف عليك.
الشاب: (متفاجئ) ماذا؟
الشابة: هل تحب زيارة الحدائق حيث يلعب الأطفال؟
الشاب: نعم.
الشابة: ألم ترَ يومًا كيف يتعامل الأطفال؟ يقول الطفل للآخر مباشرة: أريد اللعب معك!
الشاب: بلى، رأيتهم.
الشابة: وأنا أيضًا! نظرتُ إليك، وأحسست أنك شخص يستحق أن أتعرف إليه. فلِمَ لا نتحدث كلما التقينا هنا؟ لا أحتاج معرفة اسمك، ولا وظيفتك…
المشهد تمثيلي، إلا أنه استوقفني كثيرا ـ أكثر مما توقعت!
ألم تر يوما كيف يتعامل الأطفال؟
كلما سافرت مع أبناء أختي وجلست أراقبهم وهم يلعبون مع أطفالٍ لم يروهم من قبل، أستغرب.
أنا كنتُ أيضًا هكذا؟
هل كان من السهل عليَّ الاندماج مع الآخرين؟
هل كنت أقترب وأقول ببساطة: نلعب مع بعض؟
أم كنت أتردد؟ أخاف أن يرفضوني؟
أم أتساءل في داخلي: من هؤلاء؟ ولماذا يبدون مختلفين؟
ربما لم أكن خائفة مثل الآن، أو ربما نسيت كيف كنت أقترب من الآخرين دون حسابات كثيرة.
صحيح أن الأطفال الذين يعيشون في نفس الحي يعرفون بعضهم البعض بفضل آبائهم، فلا مكان هناك للخوف أو التردد…
لكن هذه ليست المسألة.
أبناء أختي مثلًا، حين نسافر إلى مدينة أو منطقة جديدة، ألاحظ دائمًا كيف يندمجون بسرعة، ويكوّنون صداقات جديدة، حتى يصبح جدولهم اليومي متناسقًا مع جداول أصدقائهم الجدد.
في آخر عطلة صيفية، كان لا يمر وقت طويل حتى أسمع أحد الأطفال ينادي من أمام الباب:
أين آسية؟ أين نوح؟
يذهبون إلى البحر معًا، يلعبون الكرة، يركضون خلف بعضهم، يتقاسمون قطع الحلوى، ويدخل كل منهم بيت الآخر كما لو كانوا يعرفون بعضهم منذ سنوات.
والأجمل أن خلفياتهم مختلفة تمامًا… ثقافيًا، اجتماعيًا، وكل شيء! ربما أكثر ما يدهشني فيهم ليس فقط سرعة انسجامهم، بل صفاء نيتهم في التواصل. ذلك التواصل البسيط غير المعقد!
دعني أخبرك بشيء لفت انتباهي، قبل أن نُكمل الحكمة من المشهد أعلاه!

اللعب (المتعة الطيبة) أساس بداية العلاقات
هناك منطقة نسافر إليها كل عام، يرافقنا فيها أبناء أختي لأسبوع أو أسبوعين.
مع مرور السنوات، تعوّدوا عليها، وتعرّفوا إلى سكان المنازل المجاورة وأبنائهم، حتى أصبحت تربطهم صداقات جميلة، تسأل فيها كل أسرة عن أطفال الأسرة الأخرى كل صيف.
لعلمك، آسية تبلغ نحو سبع سنوات، ونوح أحد عشر عامًا. (حتى أن آسية تعلّمت المشي هناك، ولديّ صورة لجدّها وهو يمسك يديها لتخطو أولى خطواتها!)
في كل صيف، حين يلتقي هؤلاء الأطفال الذين يأتون من مدن مختلفة، يفرحون ببعضهم بشدة، وينتقلون بعدها إلى اللعب بكل أنواعه.
لا أحد يسأل الآخر:
- هل نجحت؟
- كم كان معدلك؟
- ما الهدية التي حصلت عليها مؤخرًا؟
يرى أحدهم الآخر يترجل من السيارة بعد وصوله، فيركض نحوه ويحضنه بكل حب وفرح، وكأن قلبه يقول: أوه! كم اشتقت لرؤيتك يا صديقي!
هل تستطيع فعل نفس الشيء مع صديق لم تره منذ زمن طويل؟
قبل مدة، كنت أخبر صديقتي أني رأيت زميلًا قديمًا لنا من الثانوية. لمحته من بعيد يمشي في الاتجاه نفسه، فابتسمت وقلت في نفسي: أوه، فلان!
توقفت أنتظر أن يعبر الشارع لألقي عليه التحية. وفعلاً، عبر الشارع… ومرّ بجانبي كأنه لا يعرفني.
أعلم، قد تقول الآن: ربما لم ينتبه، أو لم يعرفك. وهذا ما قلته لنفسي أيضًا ـ مع أن ملامحي لم تتغير كثيرًا.
لكن هذا ليس بيت القصيد. بعد أن مرّ، وقفت للحظات أجادل نفسي:
- لماذا لم أنده عليه؟
- ربما لم ينتبه؟
- ربما لم يتعرف عليّ؟
ثم يأتي صوت آخر في داخلي: يا زهرة، لا تبالغي. زميل من الثانوية، ربما حتى نسي اسمك.
فأكملت طريقي بهدوء.
والمفارقة أني لم أحزن لأنه لم يكلمني… بل لأني أنا لم أكلمه.
لماذا أصبح التواصل البسيط ثقيلا؟
عشت مواقف كثيرة مشابهة. تلتقي عيناي صدفة بشخص أعرفه، وفجأة يلتفت إلى مكان آخر.
قبل فترة قصيرة، كنت متجهة إلى محل قريب من المنزل، ورأيته من الجهة المقابلة. كان يركب دراجته الهوائية ببطء، ولا مجال للشك في أنه رآني. ومع ذلك، مضى في طريقه كأن شيئًا لم يكن.
استغربت! (ولأضعها بين قوسين: هو نوعًا ما شخصية معروفة، لكني أعرفه منذ كنا صغارًا). فماذا تغيّر؟
حين رويتُ الموقف لصديقتي، استغربت هي أيضًا، ثم أضافت أنها تراه أحيانًا، لكنها لا تلقي التحية لأنها لا تعرفه شخصيًا. ببساطة!
قد يراها البعض مواقف تافهة لا تستحق التفكير، وقد يقول أحدهم إنني أبالغ، أو أتظاهر بأنني الطرف الطيب الذي يُلقي التحية والآخرون يتجاهلون.
لا، أبدًا. ليست القصة بهذه البساطة.
لأني أنا أيضًا بدأت أمارس السلوك نفسه ـ مع بعض الاستثناءات.
كيف يحدث ذلك؟ حين تتكرر هذه المواقف، حين يتجاهلك الناس، أو يمرون بجانبك دون كلمة، تبدأ تفكر بطريقة مختلفة: ولِمَ أهتم؟ هل أنا متفرغةٌ لهم؟
فتمضي في طريقك، ولا تسلّم إلا على من يبدأ بالسلام.
مع ذلك…
ألم نر كيف يتعامل الأطفال؟
المسافة التي تصنعها الأسئلة
بعد أن فكرت قليلًا، وعدت بذاكرتي إلى الوراء، تذكرت المواقف التي تجاهلت فيها رؤية أشخاص أعرفهم، فوجدت أن المشكلة ليست في الأشخاص أنفسهم، بل في الطريقة التي نعيد بها التواصل بعد الغياب.
تذكرت ابنة أختي، لأني رافقتها عن قرب لفترات أطول.
في كل مرة تلتقي إحدى صديقاتها بعد عام كامل، لا تسألها أسئلة معقدة أو مربكة، فقط سؤال بسيط: لباس عليك؟ ثم تنتقلان مباشرة إلى اللعب.
أما نحن؟
سلسلة من الأسئلة المرهقة والمربكة:
- هل لازلت تدرسين؟
- هل تعملين؟
- أين تعملين؟
- كيف حصلت على هذا العمل؟
- هل تزوجتِ؟
- لماذا لم تتزوجي بعد؟
- ما أخبار فلانة وفلان؟
- لماذا توقفت عن العمل؟
أسئلة لا تحمل اهتمامًا بقدر ما تحمل تحقيقًا.
على السطح، قد تبدو المسألة مرتبطة بالعمر، ونضج الأشخاص، وتطورات الحياة. فالطفل الصغير لن يتساءل إن كان صديقه يربح المال أو يعيش علاقة سعيدة.
أما نحن الكبار، فلدينا مواضيع ثابتة ندور حولها كلما التقينا:العمل، الزواج، الدراسة، النجاح، الفشل.
ومع ذلك، لا أريدك أن تنظر للأمر من هذه الزاوية فقط.
استرجع آخر صدفة جمعتك بشخص لم تلتقِ به منذ زمن. تحدثتما قليلًا، ثم افترقتما، وقلت في نفسك: يا ليتني لم ألتقِ به!
تمر الأيام أو الأسابيع، ثم تراه من بعيد… فتغيّر الطريق كي لا تلتقيه مجددًا.
لماذا يحدث ذلك؟
فكّر قليلًا. ما السبب الحقيقي وراء رغبتك في تجنب اللقاء مرة أخرى؟

عن الفضول… والمقارنة التي تفسد اللقاء
لأخبرك بقصة قد تنعش ذاكرتك.
بعد انتقالنا إلى منزل جديد، لم أعد أزور الحي القديم إلا نادرًا. ومع مرور الوقت، انقطعت معظم العلاقات، ولم أعد ألتقي كثيرًا من الوجوه المألوفة، مثل إحدى صديقات أختي.
لم أرها منذ أكثر من سبع سنوات. ومع أنها كانت صديقة أختي، إلا أني قضيت معها جزءًا طويلًا من الطفولة والمراهقة. كانت إنسانة لطيفة، متعلمة، صاحبة حس فكاهي جميل، ولدينا ذكريات كثيرة تستحق التذكر.
في أحد الأيام، رافقت صديقتي إلى منزل قريب من حينا القديم، وبالصدفة التقيت بها. فرحت لرؤيتها، وتبادلنا التحية وسألنا عن الأحوال. لكن قبل أن يطول الحديث، نظرت إلى يدي وسألتني بابتسامة فيها شيء من الفضول:
ألم تتزوجي بعد؟ لماذا؟ أكيد تتشرطين كثيرًا! ما الذي تنتظرينه؟
أجبتها بما رأيته مناسبًا في تلك اللحظة، وتبادلنا أرقام الهواتف، ثم افترقنا.
بعد عام تقريبًا، صادفتها من جديد. لم نكن قد تواصلنا أبدًا في تلك المدة. وبعد التحية المعتادة، انتقلت مباشرة لتسألني عن عملي، وقبل أن أجيب، سبقتني قائلة:
أوه، أصلًا أنتِ لا تحتاجين للعمل! كنتِ مدللة، كل ما تريدينه يأتيك بسهولة…
استغربت من كلامها. ابتسمت ابتسامة مصطنعة وقلت مازحة:
لا، لا، الآن لدينا أحفاد في العائلة، تغيّرت اللعبة!
ثم تدخلت صديقتي وأنقذت الموقف قائلة:
هيا، لقد تأخرنا.
ونحن نمشي، غمرني صمت غريب، وصديقتي أيضًا التزمت الصمت للحظات. بعد دقائق التفتُّ إليها وسألتها:
هل كانت تقصد ما فهمتُه؟ أم أني بالغت؟
ابتسمت وقالت بهدوء:
ما حدث ببساطة هو أنه في المرة القادمة… إن صادفتِها، غيّري الطريق.
عندها قلت في نفسي: أليس من الأجمل لو اكتفينا بالسؤال عن الأحوال؟ أو تذكرنا لحظاتنا القديمة دون تلك الأسئلة الثقيلة؟
لا أقول إن السؤال عن العمل أو الحالة الاجتماعية عيب، لكن الأسلوب هو ما يصنع الفرق.
تحدّث بلطف، لا تُشعر الآخر أنك تُجري معه تحقيقًا فقط لأنكما لم تلتقيا منذ زمن.
بالنسبة لي، لا أحب تلك الأسئلة، ومع ذلك، إن سُئلت بطريقة لطيفة، سأجيب بابتسامة حقيقية… ولكن ليس في اللقاء الأول بعد غياب طويل.
لا يوجد ما أخفيه!
هل تعلم ما الذي يجعلنا نقفز لطرح هذه الأسئلة المعقدة؟
- الفضول لمعرفة ما وصل إليه الآخر.
- الخوف من أن يكون قد تفوق علينا.
- والعادة المجتمعية التي تُربينا على المقارنة.
هذه الأسباب الثلاثة منطقية، مع ذلك، أنا فكرت في سبب رابع. أراه الأقرب للصواب!
ـ معظم ـ الناس، لا تهتم بجواب أول سؤال يطرحونه عليك، وهو: كيف حالك؟
عدم الاهتمام هذا، يفسر رغبتهم السريعة في تجاوز إجابتك، والانتقال للأسئلة المعقدة! لأنه، صدقا، كم مرة يسألك شخص ما كيف حالك؟ وتجيبه: بخير، وأنت أبدا لست بخير!
ليس لأنك تريد الكذب، وإنما تعودت أيضا على تجاوز هذا السؤال بسرعة. وبالتالي، أصبحنا نهتم بمعرفة ما حققه الآخرون وما وصلوا إليه، وما الذي يفعلونه في حياتهم حاليا، أكثر من اهتمامنا بمعرفة هل هم أصلا بخير؟!
صديقة لم تريها منذ مدة، أكبر همك ـ غالبا ـ هو أن تعرفي هل تزوجت وأنجبت أم ليس بعد؟! أو زميل عمل سابق، رأيته فجأة، ستريد معرفة المنصب الذي يشغله الآن!
هذا لا يعني أنك إنسان سيء، لا! هم أيضا بالمقابل يطرحون عليك نفس الأسئلة!
فكما قلت، لا يعقل أن شخصا لم تلتق به لمدة طويلة، ألّا ترغب في معرفة ما أنجزه طيلة هذه الفترة. كلمة ـ لا يعقل ـ هذه، قادمة من المجتمع.
لأن الأساس، أو الفطرة، ما هي؟
فقط، تسأل عن حال الشخص، هل هو بخير؟ هل هو فعلا بخير؟
كم شخصا تعرفه حاليا متزوج إلا أنه تعيس، مع ذلك، تنهال عليه بالأسئلة:
- اوه، متى تزوجت لم تخبرنا؟
- أين تعرفت على شريكك؟ ما هي وظيفته؟
وكم من موظف يشغل منصبا كبيرا، وهو لا يطيق وظيفته؟ أو هو فقط مُثقل بأعباءها ومسؤولياتها الكثيرة؟ وكل ما يسمعه منك هو: أنت محظوظ! على الأقل أنت تعمل! بالتأكيد راتبك مرتفع! متى تقوم بدعوتي للعشاء؟ يجب أن تقوم بعزيمة!
كم من سيدة متزوجة ولم يرزقها الله بعد بالأبناء، وتصادفها صديقة قديمة، وأول ما تسأله عنها هو، لماذا لم تنجبي للآن؟! هل زوجك لا يريد الأطفال؟
مع كل سؤال من الأسئلة ـ الغبية ـ هذه، الطرف الآخر، يحزن، يتوتر، يرتبك… يقول في نفسه: هل أكذب أم أكون صادقا؟!
- هل يخبرها أن زواجه فاشل؟
- أم يقول إنه يعمل فقط ليسد ديونه، بعد أن استنزفته الوظيفة؟
- أم تعترف تلك المرأة بأنها تبكي ليلًا لأن الله لم يرزقها طفلًا بعد؟
وفي النهاية،، أنت تعلم أننا نختار الكذب هربا من مواصلة المحادثة، ولا أحد سيجيب بالأجوبة أعلاه.
فماذا لو اكتفينا فقط بأن نسأل: كيف حالك فعلًا؟
(لا نريد أخبارا، لا نريد معلومات! كثّر الله من خير القنوات الإخبارية!)
لم نلتق منذ أشهر، أو سنوات، وتصادفنا في مكان ما، إسألني فقط كيف حالي؟ وكن مستعدا وراغبا بصدق في معرفة الإجابة وكل شيء سوف يلي هذا السؤال!
كيف ذلك يا زهرة؟
حين نسمع ولا ننتبه
يروي واين داير في أحد كتبه قصة أول لقاء جمعه بمحرر أمريكي معروف. كان صديق مقرب منه قد بذل جهدًا كبيرًا ليحصل واين على فرصة عرض كتابه الأول على ذلك المحرر.
حين دخل المكتب، كان أمامه ثلاثون دقيقة فقط ليقنعه بالنشر. لكنه لاحظ أن المحرر بدا متعبًا، كأن شيئًا يثقل قلبه.
في تلك اللحظة، سأل نفسه:
هل أستغل الدقائق القليلة لأعرض كتابي، أم أضع الكتاب جانبًا وأسأله عمّا يؤرقه؟
اختار الخيار الثاني.
جلسا يتحدثان لأكثر من ساعة عن مشاكله الشخصية، ولم يُذكر الكتاب إطلاقًا.
حين خرج، أخبر صديقه بما حصل. غضب منه وقال إنه أضاع فرصة عمره ككاتبٍ مغمور.
لكن بعد أسابيع، تلقى واين اتصالًا من ذلك المحرر يطلب منه الحضور لمكتبه مجددًا.
وحين جلس أمامه، قال له:
ذلك الكاتب الذي منحني ساعة من وقته لأتكلم عن نفسي، لا بد أن يكون كتب شيئًا يستحق القراءة.
ومنذ تلك اللحظة، عملا معًا لسنوات طويلة.
هل أقول إن علينا أن نفعل مثل واين تمامًا؟
لا، بالتأكيد لا.
لكن ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا من قصته:
أن نضع فضولنا جانبًا، ونمنح الآخر لحظة راحة… بدل أن نُغرقه في الأسئلة.
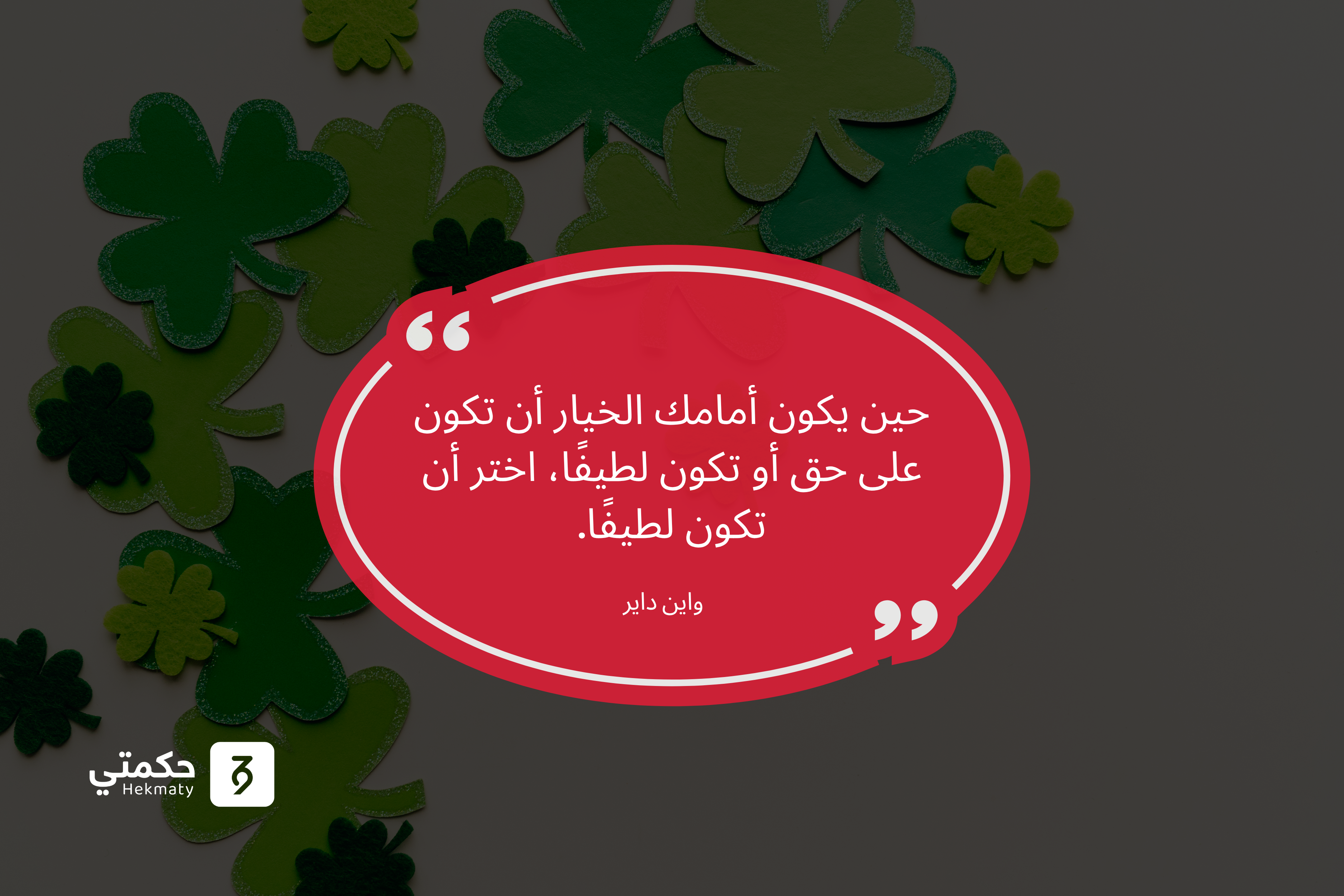
الناس، كيفما كانت تبحث عن الراحة.
في الزمن الذي نعيشه، ومع الضغوطات التي فرضناها على أنفسنا، لم يعد هناك عذر لتقبل قسوة الآخر!
في الماضي، كنا نرى القسوة في الضرب، أو الإهانة، أو الأذى الواضح.
أما اليوم، فأي تصرفٍ يمس راحتنا النفسية بات يُشعرنا بالقسوة.
وأحد أكثر مظاهرها بساطةً وألمًا، تلك المحادثات التي تبدأ بعد غياب طويل، بأسئلة معقدة.
فدعك من هذا!
كن إنسانا لطيفا هينا.
وربما أنت كذلك فعلا، إلا أنك تعودت بسبب ثقافة المجتمع أن يكون همك الأول هو معرفة أين وصل فلان؟ وما الذي حققته فلانة؟!
كن مثل الأطفال… يفرحون برؤية أصحابهم بعد طول غياب، ولا يتشرطون شيئا في بعضهم البعض!
استمتع بلقاءاتك، وإن وجدت أن الموجة عادت كما كانت، فتابع العلاقة كما تشاء، وحدد اللقاء الثاني والثالث، ودَع الأمور تنمو في وقتها المناسب.
فلكل علاقة، ولكل حديث، زمكانه الخاص.
أن نرى الناس بعين الطفل
والآن، إن كنت تتساءل عن الحكمة من المشهد الذي بدأتُ به المقالة، فأنا مترددة قليلًا… لكن الجميل في الأمر أني كاتبة، وهذا يشفع لي!
في الأخير، ما الذي يفعله الحكيم؟
يضع حكمته على الطاولة، ومن كانت لديه البصيرة، يأخذ بها.
قالت الشابة للشاب الذي لا تعرفه: مرحبا، أريد التعرف عليك! أحسست أنك شخص يستحق أن أتعرف عليه!
قبل أن أنهي هذه المقالة، لابد أن أذكّرك وأذكّر نفسي معك، أن العالم ليس مثاليًا، فهو مليء بالسيئين والمستغلين والمتحرشين…
ولن تنجح معك هذه الحكمة، إلا إن عدت كالطفل، بفطرته النقية، التي تجعله يعرف بمن يطمئنّ، وعمّن يبتعد.
وربما الحكمة كلّها في أن نجرّب أن نرى الناس:
بعين الطفل، لا بعين المقارنة،
بعين الفضول البريء، لا بعين الحكم،
بعين من يريد أن يستمتع، لا من يريد أن يعقِّد الحياة!

